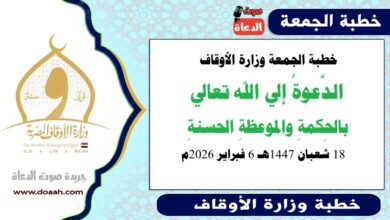وزارة الأوقاف تعلن رسميا عن زاد الأئمة والخطباء.. لـ خطبة الجمعة القادمة : إنَّ من الشجر شجرةً لا يَسقطُ ورقُها
بتاريخ 28 صفر 1447هـ ، الموافق 22 أغسطس 2025م.

زاد الأئمة : وزارة الأوقاف تعلن رسميا عن زاد الأئمة والخطباء.. الدليل الإرشادي لـ خطبة الجمعة القادمة حول : إنَّ من الشجر شجرةً لا يَسقطُ ورقُها ، بتاريخ 28 صفر 1447هـ ، الموافق 22 أغسطس 2025م.
ننفرد بنشر زاد الأئمة والخطباء.. الدليل الإرشادي لخطب الجمعة القادمة : إنَّ من الشجر شجرةً لا يَسقطُ ورقُها ، بصيغة WORD
ننشر زاد الأئمة والخطباء.. الدليل الإرشادي لخطب الجمعة القادمة : إنَّ من الشجر شجرةً لا يَسقطُ ورقُها، بصيغة pdf
ولقراءة زاد الأئمة والخطباء.. لـ خطبة الجمعة القادمة : إنَّ من الشجر شجرةً لا يَسقطُ ورقُها ، كما يلي:
بِسْمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
الخطبة الأولى: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها
الهدف المراد توصيله: التوعية بطرق وأسباب تنمية الفكر عامة والفكر النقدي خاصة
الخطبة الثانية: حفظ النفس
إنّ منَ الشجرِ شجرةً لا يسقُطُ ورَقُهَا
الحمد لله رب العالمين هدى العقول ببدائع حِكَمه، وَوَسِعَ الخلائق بجلائل نعمه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
فإن من أعظم ما ميز الله به الإنسان نعمةَ العقل والتفكير، بل جعله مناط التكليف، ووسيلة الهداية، ومدخل الإيمان، وقد تكرر في القرآن الكريم أمرُ الله تعالى بالتفكر، والتعقل، والنظر، والتدبر، من أجل ذلك كانت تنمية الفكر، فريضة شرعية، وضرورة حضارية، ومسئولية اجتماعية.
- أنموذجٌ نبويٌّ رائدٌ في التفكير النقديّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: “بَيْنَما نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ إِذَا أُتِيَ بِجُمَّارِ نَخْلَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يأكله: «ِإِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً خَضْرَاء، لَمَا بَرَكَتُها كَبَرَكَةِ المُسْلِمِ، لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَلاَ يَتَحَاتُّ، وتؤتي أكلها كلَّ حينٍ بإذنِ ربها، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ؟» قال عبد الله: فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي، فَقَالَ القَوْمُ: هِيَ شَجَرَةُ كَذَا، هِيَ شَجَرَةُ كَذَا، وَوقعَ في نَفْسي أنها النَّخْلَةُ، فَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَقُولَهَا، فَإِذَا أَسْنَانُ الْقَوْمِ، فَأَهَابُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ، ثُمَّ التَفَتُّ فَإِذَا أَنَا عَاشِرُ عَشَرَةٍ أَنَا أَحْدَثُهُمْ أصغَرُ القَومِ، وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لاَ يَتَكَلَّمَانِ فَسَكَتُّ.
فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا، قالوا: حدّثنا ما هيَ يا رسول الله؟ فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هيَ النَّخْلَةُ».
فَلَمَّا قُمْنَا قُلْتُ لِعُمَرَ أبي: والله يَا أَبَتَاهُ، لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تقولها؟ قَلتُ: لَمْ أَرَكُمْ تتَكَلَّمُونَ، لَمْ أَرَكَ وَلاَ أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّمْتُمَا، وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ، فَاسْتَحْيَيْتُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ أَوْ أَقُولَ شَيْئًا، فسَكَتُّ، قَالَ عُمَرُ: لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا”. [متفق عليه، وهذا النص جامع بين الروايات المذكورة في الصحيحين].
بيان بعض ألفاظ الحديث
الجُمّار: بوَزْن رُمّان : قَلْبُ النَّخْلَةِ وشَحْمُها، تَموتُ بقطعه، ويُستَخْرَجُ منها بعد قَطْعِها.
بَرَكَتُها: أي خَيْرُها ونَفْعُها.
ولا يتحاتُّ: أي لا يَتَساقَطُ ورقُها ولا يتناثر.
مثل المسلم: رُوي لفظ (مِثْل) بكسر الميم وسكون الثاء، كما روي (مَثَلُ المسلم) بفتح الميم وفتح الثاء، وكلاهما بمعنى واحد.
- تشبيهُ النخلة بالمسلم أو المؤمن
شبّه سيدُنا محمد صلى الله عليه وسلم المسلم أو المؤمن بالنخلة لما بينهما من أوجه شبه عظيمة؛ فالنخلة تتميز بالثبات ورسوخ الجذور، والنفع الدائم في جميع أجزائها وأحوالها، والعطاء المستمر الذي لا ينقطع، وهذه الصفات يجب أن يتحلى بها المسلم، فيكون ثابتًا على إيمانه، دائمَ النفع لمن حوله، ومستمرَّ العطاء والخير. وكما أن ورق النخلة لا يسقط، فكذلك ينبغي أن يكونَ فكر المسلم حيويًّا ومتجددًا، لا يتوقف عن النمو والازدهار.
لقد جعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم مجلسه مجلس فكر وتنشيط للعقل وتحفيز له بإلقاء المسائل التي تدفع إلى النشاط والفكر، كأنها جلسة من جلسات العصف الذهني كما يعبر أهل العلوم المعاصرة، فشحذت العقول واندفعت للتأمل والاقتراح، قال ابن عمر: “ووقع في نفسي أنها النخلة” فلما تحير الناس وتدافعت أجوبتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «هيَ النَّخْلَةُ» [د. أسامة الأزهري: خطبة جمعة متاحة على يوتيوب].
ومن أوجهُ تشبيهِ النخلة بالمسلم أو المؤمن أيضًا:
– أنها تُعَدُّ أشرَفَ الشجر وأعلاها مرتبة، بسبب كثرةِ خيرها، ودَوامِ ظلِّها، وطيبِ ثَمَرِها، ووُجودِهِ على الدوام، فإنه من حين يَطلُعُ ثَمَرُها لا يَزالُ يؤكل أنواعاً حتى يُجَدَّ تَمْراً ويُقطَع.
– وإذا يَبِسَتْ النَّخْلة يُتَّخَذُ منها منافعُ كثيرة؛ فخَشَبُها، ووَرَقُها، وأغصانُها، تُستعمَلُ جُذوعاً وحَطَباً وعِصِيّاً وحِبالاً ومَخاصِرَ وأوانيَ وغيرَ ذلك، ثم آخِرُ شيء يُنتَفَعُ به منها هو نَواها، فإنه يُتَّخَذُ عَلَفاً للإبِل.
– أما جَمالُ نباتِها ووَرَقِها، وحُسْنُ خِلْقَتها وثَمَرِها، وفارعُ طولِها وانبساقِها، ودوامُ خُضرة أوراقِها، وتماسُكُ جِذْعها أن تَلعَبَ به الرياح والأعاصير، وكريمُ ظِلِّها وفَيْئِها، لمن كان في جزيرة العرب: فمنافعُ مشهودة، ومُتَعٌ متكاثرةٌ معروفة محمودة، وقد مدَحَها الله في القرآن بآياتٍ كثيرة أيَّما مَدْح.
– وكذلك المسلم أو المؤْمِن كلّه خيرٌ ونَفْع، وبَرَكتُه عامّة في جميع الأحوال، ونفعُه مستمِرٌّ له ولغيرِه حتى بعد موته، فهو ذو عَمَلٍ صالح، وقولٍ حسن، كثيرُ الطاعات على ألوانها، ما بين صائمٍ، ومُصَلٍّ، وتالٍ للقرآن، وذاكرٍ لله، ومُذكِّرٍ به، ومُتَصَدِّقٍ، وآمرٍ بالمعروف، وناهٍ عن المنكر.
يُخالِطُ الناس ويَصبِرُ على أذاهم، آلِفٌ مألوف، ينفعُ ولا يَضُرُّ، جميلُ المَظهر والمَخبَر، مَكارمُ أخلاقِه مبذولة للناس، يُعطي ولا يَمنع، ويُؤْثرُ ولا يَطمَع، لا يَزيده طولُ الأيام إلاّ بُسُوقاً وارتفاعاً عن الدنايا، ولا تَجِدُ فيه الشَّدائِدُ والأهوالُ إلاّ رُسوخاً على الحق وثباتاً عليه، وسُمُوّاً إلى الخيرِ والنفع، وشُفوفاً عن السَّفاسِف.
عَمَلُه صاعِدٌ إلى ربِّه بالقبول والرضوان، إنْ جالسْتَه نَفَعَك، وإن شاركْتَه نَفَعَك، وإن صاحَبْتَه نَفَعك، وإن شاوَرْتَه نَفَعك، وكلُّ شأن من شئونه مَنْفَعة، وما يَصْدُر عنه من العلوم فهو قُوْتٌ للأرواح والقلوب، لا يزالُ مستوراً بدِيْنِه، لا يَعْرى من لِباسِ التقوى، ولا يَنقطِعُ عملُه في غِنىً أو فقر، ولا في صِحّةٍ أو مرض.
بل لا يَنقطع عملُه حتى بعدَ موتِه، إذا نَظَر من حياتِه لآخِرتِه، واغتَنَم من يومِه لِغَدِه، يُنتَفَعُ بكل ما يَصْدُرُ عنه حَيّاً وميتاً، إذْ مَبْعَثُ تصرُّفاتِه كلِّها الإيمانُ بالله، والنفعُ لعبادِ الله، سبحان الله ما أعظَمَ المؤمن؟! [الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم وأساليبه في التعليم].
- بعضُ ما يُستفاد من الحديث
– يمثل هذا الحديثُ المنهجَ النبويَّ في التفكير التحليلي، وتنمية الفكر النقدي، وتعليم مهارات الربط بين الأشياء، وتحفيز الاستقلال العقلي.
– اعتراف سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بما دار في نفسه، وهذا يعكس حالة من التفكير الداخلي والتردد، وهي علامة من علامات التفكير النقدي، حيث ينشأ الصراع بين الإحساس والقرار.
– قال العلماء: وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنه ينبغي للعالم أن يُميِّز أصحابَه بإلغازِ المسائل العَويصات عليهم، لِيَختبِرَ أذهانَهم، في كشف المُعْضِلات وإيضاح المُشْكِلات.
– الفكر السليم ضرورة في عصر كثرت فيه الشبهات، والفتن، والمعلومات المضللة، والدعوات الفاسدة.
– إن تنمية الفكر -عموما- والفكر النقدي -خصوصًا- في أولادنا وشبابنا ومجتمعاتنا هو صمام الأمان من الانجراف، والتقليد الأعمى، والانبهار بالأباطيل.
– استحبابُ إلقاءِ العالم المسألة على أصحابه، ليَختَبِرَ أفهامَهم، ويُرغِّبَهم في الفِكر والاعتناء، مع بيانِه لهم ما خفي عليهم إن لم يفهموه.
– التحريضُ على الفهم في العلم.
– ضَرْبُ الأمثالِ والأشباه لزيادةِ الإفهام، وتصويرِ المعاني لتَرْسُخ في الذهن، ولتحديدِ الفكر في النظر في حكم الحادثة.
– أنَّ تشبيه الشيء بالشيء، لا يَلزَمُ منه أن يكون نظيرَه من جميع وجوهه، فإنَّ المؤمن لا يُماثِلُه شيء من الجَمادات ولا يُعادِلُه.
– استحبابُ الحياء ما لم يؤدِّ إلى تفويتِ مصلحة، ولهذا تمنّى سيدنا عمرُ رضي الله عنه أن يكون ابنُه لم يَسكت.
– توقيرُ الكبير، وتقديمُ الصغير أباه في القول، وأنه لا يُبادِرُه بما فَهِمَه، وإن ظَنَّ أنه الصواب.
– أنَّ العالِمَ الكبير قد يَخفى عليه بعضُ ما يُدركه من هو دونه، لأن العلم مَواهب، واللهُ يُؤتي فضله منْ يَشاءُ.
– ما استَدلَّ به الإمام مالك رضي الله عنه، على أن الخواطر التي تقع في القلب، من مَحبَّةِ الثناء على أعمالِ الخير، لا يُقْدَحُ فيها إذا كان أصلُها لله تعالى؛ وذلك مُستفاد من تمنّي سيدنا عمر رضي الله عنه أن يكون ابنُه قد قال ما فَهِمَهُ ووقَعَ في نفسه من الصواب.
ووَجْهُ تمنّي سيدنا عمر رضي الله عنه: ما طُبِعَ الإنسانُ عليه من مَحبّةِ الخير لنفسه ولوَلَدِه، ولِتَظهَرَ فضيلةُ الولد في الفَهْم من صِغَره، وليزدادَ من النبي صلى الله عليه وسلم حُظوة، ولعله كان يرجو أن يَدعوَ له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذْ ذاك بالفهم، كما دعا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، لمّا أَدْنى إليه الماءَ إلى بيت الخلاء، مِن تلقاءِ نفسه دون سابق إشارةٍ منه صلى الله عليه وسلم، فقال : «اللهم فَقِّهْهُ في الدّين وعَلِّمْه التأويل». فكان رضي الله عنه كذلك.
– فَرَحُ الرجل بإصابةِ ولدِهِ وتوفيقِهِ للصواب.
– الإشارةُ إلى حَقارةِ الدنيا في عينِ سيدنا عمر رضي الله عنه، لأنه قابل فَهْمَ ابنه لمسألةٍ واحدة بحُمُرِ النَّعَم ـ كما جاء في رواية، مع عِظَمِ قَدْرِها وغلاءِ ثمنها.
– أنه لا يُكْرَهُ للوَلَد أن يُجيب بما عَرَف في حضرةِ أبيه، وإن لم يَعرفه الأبُّ، وليس في ذلك إساءةُ أدبٍ عليه.
– ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحياءِ من أكابرهم وأَجِلاّئِهم، وإمساكُهم عن الكلام بين أيديهم.
- القرآنُ الكريم يأمرُ بالتفكر
إن العقل هو العامل الأساسي في عملية الفكر والتفكير، ونصوص القرآن والسنة جاءت لتُحفِّز العقل لتنمية هذه العملية التي بها يكون الإبداع والاختراع والاكتشاف والعمل، قال تعالى: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} [الحج: ٤٦].
ولفظ: “العقل” لمْ يأت في القرآن الكريم جامِداً، وإنما جاءت اشتقاقاته المختلفة؛ وذلك للدلالة على أنَّ المطلوب هو قيام هذا العقل بوظائفه المتعددة، فورد بالصيغة الفعلية في تِسْع وأربعين آية، ولفظ “النظر” في مائة وتسع وعشرين آية، و”التفكير” في مائة وثمان وأربعين آية، و”التدبر” في أربع آيات، و”التفكر” في ستَّ عشرة آية، و”الاعتبار” في سبع آيات، و”التفقه” في عشرين آية، و”التذكر” في مائتين وتسع وستين آية [المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم].
ويختم الله تعالى كثيرا من آيات القرآن الكريم بدعوة العقل للتفكير والتأمل، ومثال ذلك، قوله تعالى: {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}، {لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ}، {لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ}؛ ليحفز العقل البشري على ممارسة التفكير بجميع أنواعه فيما يتلى عليه من أحكام، وكذا كثر مجي الاستفهام التوبيخي والتقريعي إنكارًا على من ألغى عقله وفكره، وأمر الإنسان بالسير في الأرض والبحث فيها؛ لأخذ العظة والعبرة من الأمم السابقة، حتى لا يصير العقل متبلداً يسلم بما يسمعه فقط {قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ} [الروم: ٤٢].
بل ذمَّ ووبَّخ مَنْ ألغى عقله، ورفض طريقتي التفكير “السطحي والسلبي” فقال سبحانه: {وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ* قُلِ انْظُرُوا ماذا فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ} [يونس: ١٠١: ١٠٢]. وقال: {وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ} [يوسف: ١٠٥].
- التفكيرُ فريضةٌ إسلاميةٌ
وصف الله عباده الصالحين أولي الألباب بأنهم يتفكرون، فقال: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [آل عمران:١٩١].
وقوله “يتفكرون” فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار، أي: أنهم دائمو التفكير في شئون دينهم ودنياهم بما يعود عليهم وعلى غيرهم بالنفع والخير.
وقال تعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ} [الأنعام:٥٠].
وهذه دعوى للتفكر، حتى يصل الإنسان من خلال عقله المرتبط بنور الوحي إلى التفريق بين النافع والضار، الخير والشر، الحق والباطل، النور والظلام.
وقد أطلق الأديب الكبير الأستاذ عباس العَقَّاد على أحد مؤلفاته عنوان: “التفكير فريضة إسلامية”، وصدَّر “مقدمته” بقوله: “من مزايا القرآن الكثيرة، مَزِيَّةٌ واضحة يقل فيها الخلاف بين المسلمين وغير المسلمين؛ لأنها تثبت من تلاوة الآيات ثبوتًا تؤيده أرقام الحساب، ودلالات اللفظ اليسير، قبل الرجوع في تأييدها إلى المناقشات والمذاهب التي تختلف فيها الآراء..، وتلك المزية هي: “التنويه بالعقل، والتعويل عليه في أمر العقيدة، وأمر التبعة والتكليف”
ثم قال في الخاتمة: “كتبنا هذه الفصول، عسى أن يكون فيها جوابٌ هادٍ لأناس من الناشئين يتساءلون: هل يتفق الفكر والدين؟.. وهل يستطيع الإنسان العصري أن يقيم عقيدته الإسلامية على أساس من التفكير؟ ونرجو أن تكون هذه الفصول تعزيزاً للجواب بكلمة “نعم” على كل من هذين السؤالين: نعم يتفق الفكر والدين، ونعم يدين المفكر بالإسلام وله سند من الفكر، وسند من الأديان” [التفكير فريضة إسلامية].
واعتبر الفيلسوف “ابن رُشد” التفكير، أو ما أطلق عليه “النظر العقلي” في الموجودات واجبًا شرعيًا حيث يساهم في إعداد المسلم للتعامل مع ظروف الحياة، واستغلال طاقات المجتمع مما يحدث تنمية شاملة مادية كانت أم معنوية.
يقول المفكر الفرنسي “بوازار”: “إنَّ هناك إجماعًا على الجهر بأنَّه لا يمكن اعتبار الإسلام مسئولاً عن جمود العالم الإسلامي الطويل، وانحطاطه الواضح، فحين كان المسلمون يَحْيَون حسب إرشادات الدين التي تحض على التفكير، وتشجع الروح النقدي، أثبت الإسلام أنَّه حامل مَشْعل التقدم والرقي” [قالوا عن الإسلام].
- تدريبُ النبيّ صلى الله عليه وسلم أصحابَه على التفكر
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ» [رواه أبو داود].
وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الاجتهاد، وأطلق الدعوة الصريحة للاستنباط وإعمال العقل واجتهاد الرأي، في حديث معاذ رضي الله عنه: لمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ» [رواه أبو داود].
وعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» [متفق عليه].
وجاء في وصفه كما في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، حيث قال: سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي رضي الله عنه، وكان وصَّافًا، قلت: صِفْ لي منطقه، قال: “كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُتَوَاصِلَ الْأَحْزَانِ، دَائِمَ الْفِكْرَةِ، لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ لَا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ، يَفْتَتِحُ الْكَلَامَ وَيَخْتَتِمُهُ بِأَشْدَاقِهِ، وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ” [المعجم الكبير للطبراني].
- التفكيرُ يعيدُ الإنسانَ إلى رشده
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: أنَّ غلامًا شابًّا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقال: يا نبيَّ اللهِ أتأذنُ لي في الزنا؟ فصاح الناسُ به، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم «قَرِّبوهُ، ادْنُ» فدنا حتى جلس بين يديْهِ، فقال النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ: «أتحبُّه لأُمِّكَ؟» فقال: لا، جعلني اللهُ فداك، قال: «كذلك الناسُ لا يُحبُّونَه لِأمَّهاتِهم، أتحبُّه لابنتِك؟» قال: لا، جعلني اللهُ فداك قال: «كذلك الناسُ لا يُحبُّونَه لبناتِهم، أتحبُّه لأختِك؟» وزاد ابنُ عوفٍ حتى ذكر العمَّةَ والخالةَ، وهو يقولُ في كلِّ واحدٍ لا، جعلني اللهُ فداك، وهو صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يقولُ «كذلك الناسُ لا يُحبُّونَه»، وقالا جميعًا في حديثِهما – أعني ابنَ عوفٍ والراوي الآخرَ -: فوضع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يدَه على صدرِه وقال: «اللهمَّ طهِّرْ قلبَه واغفر ذنبَه وحصِّنْ فَرْجَه» فلم يكن شيءٌ أبغضَ إليه منه [رواه أحمد].
فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي طغت الشهوة على عقله فمنعته التفكير، دعاه أن يزيل الغشاوة من على عينيه ويدقق النظر ويعمل الفكر، ليرى بعين مخه أن العاقبة وخيمة في الدنيا فضلا عن يوم القيامة، وهو ما فعله الشاب فعاد به إلى رشده.
- مستويات العقول والتفكير
١ ــ العقل السطحي: وهو عقل يهتم بالقشور والأخبار الكاذبة، والشائعات المغرضة، ويصدق كل ذلك ثم يَنقُلُه لغيره، وقد حذرنا النبي من هذا السلوك فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» [رواه مسلم].
٢ ــ العقل العميق: وهو عقل يفكر وينتج ويولد العلوم والمعارف ويفيد نفسه وغيره، إلا أنه لم يلتفت إلى الآخرة، ولم يعبد الله أو يشكره على نعمة العلم والمعرفة والعقل، فهو وإن أحسن إلى دنياه إلا أنه لم يحسن إلى آخرته.
٣ ــ العقل المستنير: وهو مثل العقل المتعمق في الإصلاح والتطوير والنفع العام والخاص، إلا أنه ربط نور الدنيا بنور الدين، فبنى دينه وعمَّر دنياه، وجعل الدنيا مدرجة للآخرة، فهو كما أحسن إلى الدنيا وانتفع الناس به، فقد أحسن إلى آخرته.
- أهمُّ مكوناتِ العقليةِ الإسلاميةِ الصانعة للحضارة
١- الإيمان بالله واليوم الآخر.
٢- إتقان اللغة العربية؛ لأن اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة.
٣- تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
٤- التدبر في المآلات.
٥- احترام التخصص العلمي.
٦- التثبت في الأخبار وعدم الخلط بين المصطلحات.
إن جماعات الانحراف والضلال التي شاعت وراجت بين المسلمين في عصرنا هذا، خرجوا علينا بالسلاح يقتلون أهل الإسلام، ويرمونهم بالجاهلية والردة والكفر، تلك جماعات ضلت وفقدت عقلها، قد يستنكر بعض الناس، أليس لهم “مخ”، أليسوا مكلفين؟ نعم لهم مخ، ونعم هم مكلفون أمام الله ومسئولون أمام الناس ومؤاخذون بفعلهم وجرائمهم، ولكن لكثرة ما أحاطوا هذا “المخ” بالأوهام والتخييل والخرافة والشهوة والجهل وقلة الخلق والحياء والديانة، راح سلوكهم يتجه نحوَ العنف والقتل والتدمير والإرهاب، ولا يمكن أن يكونوا عرفوا العقلية الإسلامية، ولا حصلت لهم مكونات تلك العقلية [مكونات العقل المسلم].
- إجراءاتٌ عمليةٌ لطرقِ وأسبابِ تنميةِ الفكرِ عامّة والفكر النقديّ خاصّة
– طرح السؤال كمُحفّز للتفكير؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الجواب مباشرة، بل طرح سؤالًا مفتوحًا: “فحدثوني ما هي؟” وهو أسلوب تربوي يحفّز الذهن ويُنمّي القدرة على الربط والاستنتاج.
– التدريب على التأمل والملاحظة: كما في الحديث، تأمل الشجرة، أوراقها، دوامها، والربط بينها وبين الإنسان.
– الربط بين المعلوم والمجهول: فالحديث يدعو للربط بين ظاهر الطبيعة والسلوك البشري، وهذا تمرين ذهني عظيم.
– تشجيع الفضول العلمي والمعرفي: كما فعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بإثارة فضول الصحابة بسؤال غريب ومثير.
– التفكير يبدأ بالسؤال، لا بالإجابة الجاهزة.
– لا بد من وجود البيئة التي تتقبل الخطأ والصواب؛ فلم يعنّف النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا أخطأ في الجواب، وهذه بيئة مثالية لتطوير الفكر النقدي.
– أن التفكير يحتاج إلى بيئة آمنة؛ فلم يسخر أحد من الآخر، ولم يعنّف النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا، ولم يُحرج من لم يجب، فكان ذلك مناخًا آمنًا يحفّز على التفكير والنقاش والمشاركة.
– عدم التسرع في الجواب؛ فابن عمر رضي الله عنهما لم يتكلم؛ لأنه استحيا، ولكن في قلبه جواب، وهنا نرى أهمية أن يُتاح للشباب والطلاب والمفكرين أن يُظهروا أفكارهم دون خجل، وأن يُدرَّبوا على الجرأة المؤدبة، لا التهور ولا الانكماش.
– ربط المعارف بالطبيعة والواقع: كما ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين النخلة والمؤمن، فلنربط القيم بالحياة لا بالتجريد فقط.
– غرس الشجاعة الفكرية مع الأدب، واحترام العلماء، والنقد البناء لا الهدام، وأن نغرس فيهم الفكر النقدي: الذي لا يقبل كل قول بلا دليل، ولا يصدق كل خبر بلا تثبت، ولا يسير مع كل تيار بلا وعي.
– احترام العقل، وعدم تعطيله: لا تقل لابنك مثلا: “لا تفكر.. لا تناقش”، بل قل: “فكر بأدب.. ناقش بعلم”.
– ينبغي تعويد الأبناء على السؤال والنقاش، ولا تسخر من أي سؤال، ولو ظننته بسيطًا.
– قراءة القصص الفكرية؛ وذلك باختيار قصص تحتوي على مواقف أخلاقية وفكرية معقدة، وتوجيههم لتحليلها.
– اقرأ لمن يخالفك كما تقرأ لمن يوافقك، فبذلك تنضج العقول، وتتسع الآفاق.
اللهمّ ارزقنا عقولًا راشدة، وقلوبًا واعية، وألسنة صادقة، يا الله يا كريم.
***
الخطبة الثانية
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه؛ أما بعد:
فإن الله كرّم الإنسان، وأمر بحفظ النفس، ونهى عن قتلها، وجعل من مقاصد الشريعة صيانتها، وإن حفظ النفس لا يعني فقط عدم القتل، بل يشمل كل ما يؤدي إلى إتلاف النفس أو تعريضها للهلاك، سواء كان ذلك بـ:
١- الانتحار نتيجة الاكتئاب أو الفشل أو الضغط.
٢- القيادة المتهورة التي تزهق الأرواح على الطرقات.
أولًا: خطر الانتحار
وهو من الكبائر العظيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ِمن قتل نفسه بشيء، عُذب به يوم القيامة» [متفق عليه].
إن “الحياة هبة الله، ولذلك يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الإقدام على التخلص من الحياة، مهما كانت بواعثه، ومهما قست بالمرء نوائبُ الزمان، فمن المعلوم أن هذه الدنيا دار شقاء، وليس للمصائب والمتاعب إلا الرجال، وبقدر تحمل الرجل لكبار المصائب تكبر رجولته، وبقدر جزعه وانهياره أمام بعضها يظهر ضعفه وجبنه.
وقد علمتنا التجارب أن طريق السعادة مفروش بالأشواك، ومن أراد القمة تسلق الصعاب، ودون الشهد إبر النحل، وبالجهاد والصبر والتفويض يبلغ الإنسان ما يريد، ومن ظن أنه بانتحاره يتخلص من الآلام فهو واهم، لأنه إنما يدفع بنفسه من ألم صغير إلى ألم كبير، ومن ضجر محدود، وفي زمن قصير، إلى ضجر غير محدود، وفي زمن طويل.
إن الذي يقدم على الانتحار غير راض بالقضاء، محارب للقدر ساخط على الفعال لما يريد، يائس من روح الله، وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن أجل هذا كانت عقوبته عند الله قاسية”. [فتح المنعم]
ومن الأسباب المعاصرة التي تؤدي للضيق النفسي وأحيانا الانتحار: الإخفاق في الامتحانات وفي أعقاب ظهور النتيجة، وهنا لا بد من التسليم بقضاء الله وأن نعرف أن أمر المؤمن كله خير مع الأخذ بالأسباب طبعا، ويجب أن نعلم أولادنا أن الامتحان ليس نهاية العالم، وأن النتيجة لا تعني فشلك في الحياة، بل هي محطة من محطات التعلّم والتجربة، ولنبتعد عن الضغط الزائد، واللوم القاسي، والمقارنة بالآخرين.
ثانيًا: التهور في الطرق والمواصلات
فكثير من حوادث الطرق سببها: السرعة الجنونية، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، والقيادة بدون رخصة أو أهلية، وتجاوز الإشارات، وعدم احترام قواعد السير. قال صلى الله عليه وسلم: «ِمن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم» [رواه مسلم]، ويشمل ذلك من يتسبب عمدًا أو إهمالًا في قتل نفسه أو غيره.
- إجراءاتٌ عمليةٌ لحفظِ النفسِ
– تقوية الإيمان والرضا بقضاء الله؛ فاليأس من رحمة الله سبب كثير من حالات الانتحار.
– التأكيد على أن تعرض الإنسان للمشكلات يتطلب محاولة حلها، وطلب العون من الآخرين، وليس معناه أن يُنهيَ الإنسانُ حياته لإنهاء الأزمات.
– دعم الشباب نفسيًا واجتماعيًا.
– احترام قوانين المرور؛ فإنها ليست مجرد قوانين دنيوية، بل من حفظ النفس الذي أوجبه الدين.
اللهم احفظنا بحفظك، واحرسنا بعينك، وانزع من قلوبنا التهور واليأس، واجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
* مراجع للاستزادة
– التفكير فريضة إسلامية، عباس العقاد.
– قانون الفكر الإسلامي، د. محمد عبد المنعم القيعي.
– فكر المسلم وتحديات الألف الثالثة، د. نور الدين عِتْر.
– مكونات العقل المسلم، د. علي جمعة
_____________________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة القادمة
وللإطلاع علي قسم خطبة الجمعة
وللإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات
للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع و خطبة الجمعة القادمة
وللمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف